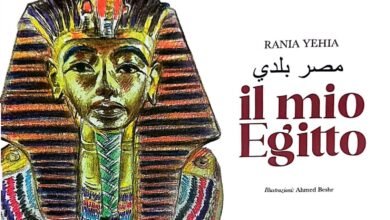د.أيمن صابر يكتب: الشاعر أمل دنقل وزرقاء اليمامة(٢)

الشاعر أمل دنقل وزرقاء اليمامة، قراءة الشعر تحتاج إلى آليات كثيرة، قبل إصدار أي نقد أو تعليق على قصيدة من القصائد، وبعد القراءة والتأمل والمقارنة، قد يفتتن القارئ بكلمات القصيدة، وتتحول إلى أفضل قصيدة لديه، والمحبوبة التي لا يمل من قراءتها أو سماعها أو إلقائها أمام حشد من المستمعين، ومن ثم يصير مبدعها من أحب الشعراء إلى نفسه، أو يصير شاعره الأول بقصيدته، وهو ما تختلف الأذواق فيه وتتعدد الرؤى؛ فما يراه أحدنا حسنا قد يراه الآخرون بصورة مخالفة أو مغايرة، وربما يصدم برأي آخر يقول له: لا أحب هذا الشاعر أو لا تروق لي أشعاره، وليست هذه القصيدة مفضلة عندي، وهو أمر منطقي لا خلاف فيه، ولا عيب في أن تتعدد الآراء؛ اتفاقا واختلافا، دون أي صورة من صور التعصب أو الميل أو تخطئة الآخرين.
ولا يزال الحديث موصولا عن قصيدة “البكاء بين يدي زرقاء اليمامة” للشاعر أمل دنقل، لما فيها من معان وصور وثقافة واستشراف، تميز بها شاعرنا عن غيره من الشعراء، ففرضت إعادة قراءتها مرة بعد مرة؛ فالقصيدة تعايش أحداثا تتكرر بصورة تدفعنا أحيانا إلى الانحياز إلى القائلين بأن التاريخ يعيد نفسه، والقول أيضا بأنه ما أشبه الليلة بالبارحة؛ خاصة حين يستدعي الشاعر أحداث التراث التاريخي وأساطيره المتعددة، ويوظفها في التعبير عن خلجات نفسه ومشاعره، ويصب فيها رؤيته عن الماضي والحاضر، ويستشرف من خلالها نبوءات المستقبل؛ وفي هذا الشأن يقول، وهو منكسر النفس، يشعر بالذل والمهانة والعجز والخذلان، فيسأل وهو العليم بكل شيء:
(1)
أسأل يا زرقاءْ ..
عن فمكِ الياقوتِ عن، نبوءة العذراء
عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكاً بالراية المنكَّسة
عن صور الأطفال في الخوذات.. ملقاةً على الصحراء
عن جاريَ الذي يَهُمُّ بارتشاف الماء..
فيثقب الرصاصُ رأسَه .. في لحظة الملامسة!
عن الفم المحشوِّ بالرمال والدماء!!
(2)
أسأل يا زرقاء ..
عن وقفتي العزلاء بين السيف .. والجدارْ!
عن صرخة المرأة بين السَّبي. والفرارْ؟
كيف حملتُ العار..
ثم يعود إلى نفسه، وكأنه يقول لنفسه لماذا أسأل وأنا أعلم الإجابة، كما أنني جزء من الإجابة، فأنا من شارك في الذل والمهانة، ولم أتحرك أو أفعل شيئا، لم ألوم وأنا واحد من صانعي هذه الأحداث، وهذه كانت من تأثيرات صدمة نكسة 1967؛ فكل الناس في حيرة من هول ما حل بهم، صدمة زلزلت الكيان، فيعنف نفسه قائلا:
ثم مشيتُ؟ دون أن أقتل نفسي؟! دون أن أنهار؟!
ودون أن يسقط لحمي .. من غبار التربة المدنسة؟!
ثم يعود فيطلب أن يفهم الأحداث ويسترجعها، ويبين شدة ما يعانيه، وشدة ما حوله، وهي صدمة من يرفض الواقع ويعلن عدم الاستسلام، ويقدم صورة مؤثرة عن حالتها النفسية؛ فيقول مستحضرا بعض المشاهد، ومستمرا في البحث عن إجابات:
لا تغمضي عينيكِ، فالجرذان ..
تلعق من دمي حساءَها .. ولا أردُّها!
تكلمي … لشدَّ ما أنا مُهان
لا اللَّيل يُخفي عورتي .. كلا ولا الجدران!
ولا اختبائي في الصحيفة التي أشدُّها ..
ولا احتمائي في سحائب الدخان!
.. تقفز حولي طفلةٌ واسعةُ العينين .. عذبةُ المشاكسة
(كان يَقُصُّ عنك يا صغيرتي .. ونحن في الخنادْق
فنفتح الأزرار في ستراتنا .. ونسند البنادقْ
وحين مات عَطَشاً في الصحَراء المشمسة ..
رطَّب باسمك الشفاه اليابسة ..
وارتخت العينان!)
فأين أخفي وجهيَ المتَّهمَ المدان؟
والضحكةَ الطروب : ضحكتهُ..
والوجهُ .. والغمازتانْ؟!
ثم ينتقل الشاعر إلى استحضار شخصية عربية تاريخية، ورمز من رموز العبودية والواقع الأليم، وهي شخصية عنترة بن زبيبة كما كانوا ينادونه في قبيلته، وهو في الحقيقة عنترة بن شداد، وكي يغير البطل هذه المقولة ويدفعهم إلى الاعتراف به قدم تضحيات كبيرة، وأولها من وجهة نظره هي البوح والإعلان عن حقيقة نسبه، فما جلب له السكوت غير الخزي والعار، فكأنه يطلب من نفسه أن تتكلم وتعلن حقيقة ما عرفه مهما كلفه ذلك من مواجهة مصاعب وعقبات؛ فالانتقال من حياة العبودية والرق إلى حياة السادة والأحرار هو ما كان يشغله ويسعى في تحقيقه، فلا سبيل أمامه إلا أن يكون عنترة بن شداد:
لا تسكتي .. فقد سَكَتُّ سَنَةً فَسَنَةً ..
لكي أنال فضلة الأمانْ
قيل ليَ “اخرسْ..”
فخرستُ.. وعميت.. وائتممتُ بالخصيان!
ظللتُ في عبيد (عبسِ) أحرس القطعان
أجتزُّ صوفَها ..
أردُّ نوقها ..
أنام في حظائر النسيان
طعاميَ : الكسرةُ .. والماءُ.. وبعض الثمرات اليابسة .
وها أنا في ساعة الطعانْ
ساعةَ أن تخاذل الكماةُ.. والرماةُ.. والفرسانْ
دُعيت للميدان!
أنا الذي ما ذقتُ لحمَ الضأن..
أنا الذي لا حولَ لي أو شأن..
أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان ،
أدعى إلى الموت .. ولم أدع الى المجالسة!!
ويعود مرة ثانية إلى أحداث التاريخ متسائلا ومعلنا عن الحقيقة التي تحيط به من هوان وانكسار، باحثا عن الخلاص، طالبا الإجابة عن أسئلته، فما يراه بعينيه لا يدعو إلى الأمل والتفاؤل، بل إنه يكاد يجن من حالة الرضوخ والاستسلام، وهنا يكشف الشاعر الجنوبي عن فكره الذي يكمن في نشأته في صعيد مصر؛ الدم الحامي والانتصار للمبادئ والقيم والأعراف، ومبدأ القوة “فما أخذ بالقوة لا يعود إلا بالقوة”؛ فالانتظار عنده انكسار، ولا وقت للبكاء:
أسائل الصمتَ الذي يخنقني :
” ما للجمال مشيُها وئيدا..؟!”
أجندلاً يحملن أم حديدا..؟!”
فمن تُرى يصدُقْني؟
أسائل الركَّع والسجودا
أسائل القيودا :
” ما للجمال مشيُها وئيدا..؟!”
” ما للجمال مشيُها وئيدا..؟!”
ورغم أنه شاعر، ولا يملك سوى الكلمات، فإن يرى -في هذا الموقف العصيب- عدم جدوى الكلمات، والدليل أن زرقاء اليمامة قالت ما قالت دون جدوى؛ فلم يصدقها أحد، وقوبل الكلام بالاستهزاء والنكران وقلب الحقائق حتى حلت الكارثة، وصاروا يطلبون النجاة والفرار، ولكن بعد فوات الأوان، ووقع الكل في الأسر والخذلان، وصاروا جميعا بين المطرقة والسندان:
ماذا تفيد الكلمات البائسة؟
قلتِ لهم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ..
فاتهموا عينيكِ، يا زرقاء، بالبوار!
قلتِ لهم ما قلتِ عن مسيرة الأشجار..
فاستضحكوا من وهمكِ الثرثار!
وحين فُوجئوا بحدِّ السيف: قايضوا بنا..
والتمسوا النجاةَ والفرار!
ونحن جرحى القلبِ،
جرحى الروحِ والفم.
لم يبق إلا الموتُ..
والحطامُ..
والدمارْ..
وصبيةٌ مشرّدون يعبرون آخرَ الأنهارْ
ونسوةٌ يسقن في سلاسل الأسرِ،
وفي ثياب العارْ
مطأطئات الرأس.. لا يملكن إلا الصرخات الناعسة!
ها أنت يا زرقاءْ
وحيدةٌ … عمياءْ!
وما تزال أغنياتُ الحبِّ .. والأضواءْ
والعرباتُ الفارهاتُ .. والأزياء!
فأين أخفي وجهيَ المُشَوَّها
كي لا أعكِّر الصفاء .. الأبله.. المموَّها.
في أعين الرجال والنساء؟ْ!
وأنت يا زرقاء ..
وحيدة .. عمياء!
وحيدة .. عمياء!
إن الشاعر الجنوبي أمل دنقل قد انتصر لمبادئه وفطرته السليمة؛ فلم يعرف الاستسلام، وحذر من عدم الإيمان بالحقائق الثابتة، والسير في طريق الغي والخذلان؛ فـ “زرقاء اليمامة” ثاقبة الرؤية، صادقة النبوءة، ولم تكن الرؤية عندها مقصورة على عينين يمتلكهما كل إنسان، ولكنها كانت ترى بقلبها، وهو ما ذكره رب العالمين حين قال: “فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور