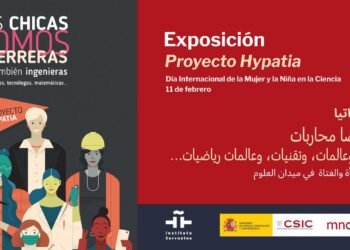علم لغة النص وفن بناء المعنى
“الأدب الصغير” و”الأدب الكبير” لابن المقفع نموذجًا
يُعَدّ علم لغة النص (Text Linguistics) من أبرز فروع اللسانيات الحديثة التي نشأت استجابةً لحاجة الدرس اللغوي إلى تجاوز حدود الجملة التقليدية المفردة، والانفتاح على مستويات أوسع وأكثر رحابة للخطاب. فالنص، بوصفه وحدةً لغوية كبرى لا يحتوي على وحدة أكبر منه، هو المجال الأشمل الذي تتحقق فيه مقاصد المتكلم، وتتجلى فيه قدرة اللغة على التنظيم والتأثير والإقناع. وإذا كانت الجملة قد مثّلت محور الدراسة التقليدية للنحو، على مدار مئات السنوات الماضية، فإن النص بوصفه كائنا حيا أصبح مع تطور المناهج اللسانية وحدةً مركزيةً تتجاوز البنية الشكلية لتلامس وظائف متعددة؛ التداولية والدلالية والاتصالية.
مفهوم علم لغة النص
وهو من المصطلحات الشائكة التي كلما يذكر لها تعريف يوجه إليها النقد والاتهام بالنقص؛ بسبب تعدد مصادره وكثرة منابعه، ولكنه يُقصد به ذلك التخصص اللساني الذي يعنى بدراسة النصوص في بنيتها الكلية، وعلاقات أجزائها، والوسائل التي تضمن انسجامها واتساقها؛ سواء على المستويات الظاهرة أو الباطنة. فالنص ليس مجرد تتابع عشوائي من الجمل المتتابعة، بل هو بناء لغوي متكامل، تحكمه قوانين داخلية تجعل منه وحدةً دلاليةً متماسكة. وقد أسهم العديد من الدارسين مثل رقية حسن وهاليداي (Halliday) في كتابهما عن وسائل الربط في اللغة الإنجليزية، وروبرت دي بوجراند (Beaugrande) ومعاييره السبعة التي تحقق النصية في بلورة هذا الاتجاه، مؤكدين أن النص لا يتحقق إلا إذا توافرت فيه معايير معينة أهمها: الربط النحوي Cohesion والربط الدلالي Coherence
إنّ النظر إلى النص باعتباره وحدةٍ كبرى يقتضي البحث في شبكة العلاقات التي تنسج بين جمله وفقراته، بحيث يفضي أولُه إلى آخره، وتعمل أجزاؤه جميعًا على إنتاج شكل كلي موحد. وهذا ما يميز النص عن مجموعةٍ متفرقة من الجمل التي لا تربطها علاقة دلالية أو وظيفية.
التماسك النصي: جوهر علم لغة النص
يُعَدّ التماسك النصي من أبرز القضايا التي يتناولها علم لغة النص. وهو يعني الروابط التركيبية الشكلية الظاهرة والوسائل اللغوية التي تحقق اتصال الجمل وترابطها؛ سواء متتابعة أو متفرقة. ومن دون هذه الروابط، يفقد النص بنيته العضوية ويتحول إلى شذرات متفرقة. ويقوم التماسك على مجموعة من الوسائل، أهمها:
الإحالة :(Reference) وتتمثل في استعمال الضمائر أو أسماء الإشارة أو الأدوات المرجعية التي تعيد القارئ إلى عنصر سابق أو تحيله إلى لاحق؛ والاستبدال (Substitution): ويقصد به تعويض عنصر لغوي بعنصر آخر لتجنب التكرار المباشر؛ الحذف (Ellipsis): وهو حذف عنصر يفهم من السياق، مما يحقق الإيجاز ويزيد من ترابط الجمل. والوصل (Conjunction): وتشمل أدوات العطف مثل (الواو، الفاء، ثم…إلخ) أو الروابط السببية مثل (لأن، إذن، لذلك). فهي وسائل تنظّم العلاقة المنطقية بين الجمل، وكذلك الربط المعجمي بالتكرار بأنواعه المتنوعة، والتضام، والسبك الصوتي.
من الربط النحوي إلى الدلالي
وإذا كان التماسك يعني الروابط الشكلية، فإن الانسجام يشير إلى الجانب الدلالي والمعرفي؛ أي إلى قدرة النص على أن يقدم معنى موحَّداً من خلال العلاقات بين الأفكار، وتماشيها مع السياق الثقافي والمعرفي للقارئ. فالانسجام يتحقق حين يلمس المتلقي أن النص يجيب عن سؤال أو يعالج موضوعاً بانتظام، دون تناقض أو قطيعة في المعنى. ومن هنا يتضح أن التماسك والانسجام وجهان متكاملان: أحدهما شكلي نحوي، والآخر دلالي معرفي.
وسائل علم لغة النص في تحقيق التماسك
لقد طور علم لغة النص جملةً من الوسائل النظرية والمنهجية لضمان بناء نصي متماسك، منها: التحليل التداولي (المقام والمتكلم والمتلقي)، التحليل السياقي وعلاقته بسياق الخطاب الأوسع: التاريخي، الثقافي، الاجتماعي، والتحليل البنائي (العلاقات الشكلية والروابط الداخلية للجمل والفقرات)، باعتبارها عناصر تحكم بناء النص، والتحليل الدلالي: بهدف الكشف عن الحقول المعجمية والعلاقات المفهومية التي تجعل النص وحدةً معنوية متجانسة، والتحليل التواصلي: بوصفه رسالة، فيُحلَّل على أساس مدى تحقيقه لوظائف الاتصال: الإعلام، الإقناع، التأثير، التوجيه.
دور التماسك النصي في التواصل
لا يقتصر التماسك النصي على كونه خاصية لغوية جمالية، بل هو ضرورة تواصلية. فالنص المتماسك يسهُل فهمه، ويحقق مقاصده لدى المتلقي، بينما يؤدي غياب التماسك إلى الغموض والتشتت. ولهذا، فإن الكُتّاب والخطباء والمبدعين يولون عناية فائقة لصناعة الروابط بين الأجزاء، حتى يُحكِموا بناء نصوصهم، ويضمنوا وقعها في النفوس؛ ومن ثم فهو يؤدي أدوارا متعددة في مجالات مختلفة؛ مثل: التعليم، والترجمة، والإعلام، والأدب.
علم لغة النص والتراث العربي
على الرغم من أن “علم لغة النص” يذكر بعض الباحثين أنه حديث النشأة، فإن الحقيقة غير ذلك؛ حيث نجد في كتب التراث في النحو والبلاغة كثيرًا من مباحث “علم لغة النص” في صورة مقتطفات وأبحاث وإشارت، وبأسماء مغايرة كالبيان والوصل والفصل والربط والعطف. فعلى سبيل المثال تحدث البلاغيون عن التناسب بين الكلام وأجزائه، وعن حسن التخلص والانتقال، وعن الوصل والفصل، وكلها مفاهيم تشير إلى ما ندرجه اليوم تحت ما عرف بـ “التماسك النصي”، وتوجد دراسات وأبحاث تؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذا الاسم، وإن كان جديدا، إلا أن العرب عرفوه قديما وتعاملوا معه وبينوا أهميته، وإن اختلفت المصطلحات والمناهج والنظريات.
وعلى الرغم من كل ما ذكرناه في أن النشأة عربية الأصل، فإن علم لغة النص يشكّل نقلة نوعية في الدرس اللغوي الحديث؛ إذ وسّع مجال البحث، وساعد في الانتقال بالرؤية الضيقة المتمثلة في الجملة إلى النص بوصفه كلاً متكاملاً، ووحدة واحدة متكاملة. ويظل النص وحدةً عضوية مترابطة، تعبّر عن مقصد صاحبها، وتؤثر في متلقيها، وتؤكد أن اللغة ليست تراكيب معزولة فحسب، بل هي كتلة واحدة متماسكة يشد بعضها بعضا، ظاهريًّا وباطنيًّا.
“الأدب الصغير” و”الأدب الكبير” لابن المقفع
كل هذه الأدوات الظاهرة والخفية كان لزاما علينا من اختبارها على نص عربي أصيل، لبيان صور التماسك النصي فيه، والكشف عن أدواته، وبيان وسائله المتعددة؛ فكان اختيار لكتابيْ ابن المقفع: “الأدب الصغير” و”الأدب الكبير” لابن المقفع الذي صدر حديثا بدراسة نصية موسعة عن بيت الحكمة، تحقيق: أحمد زكي باشا، وتقديم ودراسة: الدكتور أيمن صابر سعيد- لسببين؛ الأول؛ وهو أن ابن المقفّع يُعَدُّ واحدًا من أبرز أعلام الفكر والأدب في التُّراث العربي الإسلامي. جمع بين ثقافة عربية أصيلة ومعارف فارسية ويونانية، فكان نتاجه جسرًا حضاريًّا أغنى المكتبة العربية. ويأتي كتاباه “الأدب الصغير” و”الأدب الكبير” شاهدين على نضج فكره وعمق رؤيته؛ حيث جمع فيهما بين التوجيه الخُلقي والتربية العقلية، وربط بين تهذيب الفرد وصلاح المجتمع، مع إبراز أهمية الحكمة العملية في حياة الإنسان.
وأما الثاني، فهو أن هذين النصّين يمتازان بقدرة لافتة على صوغ المعنى الأخلاقي في لغة رشيقة موجزة ومتماسكة وبطريقة تربوية ذات نزعة إصلاحية، تحمل من العمق ما يجعلها مادةً ثريّة للدراسة والبحث -سواء على المستوى التركيبي أو المستوى الدلالي- ومرجعًا لا غنى عنه لفهم طبيعة التفكير الأخلاقي والسياسي في بدايات الحضارة العربية الإسلامية؛ فضلا عن أنهما يمنحان الأدب العربي قيمةً معرفية وفلسفية تتجاوز حدود عصر ابن المقفع، ويظلان مصدر إلهام للأجيال القادمة.