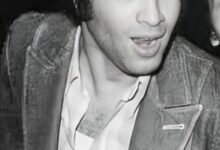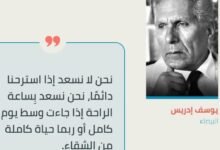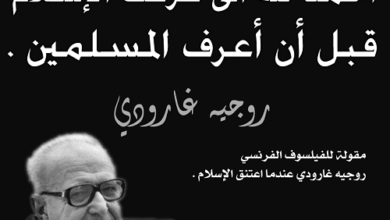د. أيمن صابر سعيد يكتب: بلاغة المقموعين

بلاغة المقموعين
ليس بغريب أن يحيا الإنسان حياته بين العطاء والمنع، أو بين القبول والرفض، بين أريد وغيري يريد، ومن ثم فإذا نظرنا إلى عملية القمع نستطيع أن نقول بأنها عملية شعورية تدور في فلك المنع بوجه عام، منع من ممارسة حق أو من تحقيق رغبة أو أمنية أو التصدي لشيء ما ومنع حدوثه، تحت إرادة وقوة وتحكم. ومن ثم يتجه الفرد، سواء عن قصد أو غير قصد، إلى وسائل دفاعية مختلفة.
وتتمثل هذه الوسائل، حسب طبيعة كل فرد وما يتناسب معه؛ اختياريا أو إجباريا، ومنها الوسائل الدفاعية التي تتمثل في العدوان Aggression، سواء على الذات نفسها أو على الآخرين؛ نتيجة طبيعية لأزمة شديدة أو معوقات شديدة الصعوبة بالغة التعقيد، بطريقة شعورية أو لا شعورية، أو ربما في صورة كيدية أو تشويه صورة الآخرين أو الامتناع عن الوقوف إلى جوارهم،
بل وقد يخرج الأمر إلى تعمد إحداث أضرار بالجماد نتيجة عدم الإشباع، أو رمي الأشياء بعنف وسبها، أو إيذاء النفس البشرية كنوع من التعبير عن حالة نفسية مرضية متأزمة غير طبيعية، تصل إلى ما هو أبعد من ذلك، كالرغبة في التخلص من الآخرين بالقتل أو التخلص من النفس بالانتحار؛
أو وسائل دفاعية إسقاطية projection كنسب العيوب والرغبات إلى الآخرين، أو إلقاء اللوم على الناس والأشياء والأقدار(في حالة التذبذب وقلة الإيمان)،
وقد نسمع منهم قولهم ليس لدي حظ، أو لدي سوء حظ، وما إلى ذلك من العبارات المنتشرة في تراثنا الشعبي، وإذا كان الأمر في حدوده الطبيعية فلا توجد مشكلة، ولكن المشكلة تكمن حين ينتقل من الحدود الطبيعية إلى الحدود غير الطبيعية المرضية.
وهناك وسائل دفاعية انسحابية؛ حيث يرى الفرد أن من الأفضل لنفسه وصحته الابتعاد عن الموقف المتأزم الذي يسبب له القلق والأذى، كالابتعاد عن الناس بوجه عام، سواء عن طريق انسحاب نفسي نتيجة إحساس بالإحباط الشديد أو انسحاب مادي كعدم الرغبة في الأجواء الاجتماعية، ومن صورها الدفاعية الانطواءIntroversion، والأحلام في اليقظة والنوم، والنكوصRegression ، والإنكارDenial ، والتبرير Rationalization …إلخ.
وهناك وسائل دفاعية إبدالية، كإبدال أهداف بأهداف، أو إبدال الكل بالجزء أو العكس، أو إبدال نشاط بنشاط، أو أشخاص بأشخاص، ومن صورها النقل، أو التعميم Generalization، أو التسامي Sublimation، أو التعويض Compensation …إلخ
بل وهناك حيل دفاعية أخرى تتمثل في الاحتماء بالمرض النفسي، وقبول فكرة أنه مريض نفسي ويحتاج علاجا نفسيا، وهو مبرر استعطافي يتمثل في الهروب والتبرير وعدم إلقاء اللوم في حالة حدوث أي أخطاء، فهو لا يخجل في هذه الحالة أن يصرح بأنه يتعالج نفسيا، وأن المريض ليس عليه أي حرج،
وأن الأمر كله خارج حدود سيطرته، ويجب على الآخرين تحمل تصرفاته وأخطائه وعدم إنزال العقاب به، مهما حدث منه أو مهما فعل، حتى لو صل الأمر إلى إيذاء الآخرين.
كانت هذه صورة سريعة عن فكرة القمع، وكيفية تعامل المقموع معها، بوسائله الدفاعية المختلفة التي يتخذها كرد فعل أو تعبير عما يتعرض له من قمع، وهذا الأمر تعرض له الشعراء والأدباء والكتاب والمبدعين بوجه عام، بإحدى الصور السابقة الذكر كنوع من الدفاع عن أفكار أو مشاعر أو آراء أو وجهات نظر أو طلب حقوق،
أو رفض لواقع معين معيش، أو شعور بانتقاص من الحقوق الطبيعية أو الحقوق المؤملة، وإن كانتوسائل التعبير عن ذلك تختلف من فرد لفرد؛ فقد يرى أحدهم أن قمة البلاغة في الصمت كوسيلة دفاعية مهما بلغ القمع، ومهما تعددت صوره، ومن ذلك قول الشاعر أبي نواس:
مُتْ بداءِ الصَّمت خير لك من داء الكلام
إنما السـالـمُ مَن ألجـــــــــــــــمَ فاهُ بلجام ولم يتوقف الأمر على الشعر فحسب- كما ذهب الدكتور جابر عصفور وغيره في مؤلفتهم، بل امتد الأمر إلى غيره من الفنون الكتابية أو القولية، التي تعبر عن العلاقة بين القامعين والمقموعين وبلاغتهم، والتراث الشعري والنثري يعج بنماذج خصبة دالة على الأساليب البلاغية الكتابية التي تحمل فكر أصحابها،
وتعبر عن آرائهم ومبادئهم وتوجهاتهم، بوسائل إقناعية متنوعة مبنية على الفروع البلاغية المختلفة؛ علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، تحت مظلة أساسية للبلاغة نفسها التي كانت ماثلة في ذهن القدماء بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والتأكيد على أن لكل مقام مقالا، ومراعاة المقامات والأحوال أمر ضروري لتحقيق الهدف الأساسي الذي من أجله خرج الكلام،
وإلا فإن الصور البلاغية في حالة عدم مراعاة ذلك أو في حالة عدم جدوى الكلام أو في حالة أن الكلام سيترتب عليه ضرر أو مفسدة سيكون الصمت والسكوت، ولذلك جاء الصمت مساويا للبلاغة ومعبرا عنها. ومن ذلك قول الشافعي:
إذا نطقَ السفيهُ فلا تُجِبْهُ
فخيرٌ من إجابتِهِ السكوتُ
فإن كلَّمْتَهُ فرَّجْتَ عنــْهُ
وإن خلَّيْتَهُ كمدًا يموتُ !
بل إن للصمت فوائد ومنافع، ومما جاء في فضائل السكوت:
قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم
إن الجواب لباب الشر مفتاح
والصمت عن جاهل أو أحمق شرف
وفيه أيضا لصون العرض إصلاح
أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة
والكلب يخسى لعمري وهو نباح
ومصطلح “البلاغة” اصطبغ بصبغة مستخدميه من نحاة ولغويين ومفسرين ومتكلمين وغيرهم، واختلف تبعا لتأويلاتهم، وإن اتفق الكثير من الباحثين في هذا الشأن، على أنه ارتبط في البداية بقضية “الإعجاز”؛ لذا يمكننا تتبع ذلك في مؤلفاتهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: “إعجاز القرآن” للباقلاني، و”بيان إعجاز القرآن” للخطابي، و”النكت في إعجاز القرآن” للروماني، و”معنى القرآن” للفراء، و”تأويل مشكل القرآن” لابن قتيبة، و”دلائل الإعجاز” للجرجاني، و”بديع القرآن” لابن أبي الإصبع، و”الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق القرآن” وغيرها، سواء في مؤلفات مستقلة، أو مباحث أو رقائق لطيفة متعلقة بهذا المصطلح، وهناك أقوال كثيرة منها: “ما قرب طرفاه وبعد منتهاه”، و”التقرب من البغية ودلالة قليل على كثير”، و”البلوغ إلى المعنى ولم يطل سفر الكلام”، و”دنو المأخذ والقصد إلى الحجة”.
ولذا، فإن تعريفات القدماء للبلاغة قد تعددت -فعلى سبيل المثال- يقول الجاحظ: “لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك”. وهناك من يعقد مقارنة بين البلاغة والفصاحة كالعسكري، ويفرق بينهما، فقد يكون الكلام فصيحا بليغا، وقد يكون الكلام بليغا وليس فصيحا. وهناك من يجعل البلاغة شاملة للألفاظ والمعاني، ويراها أخص من الفصاحة كابن سنان الخفجي.