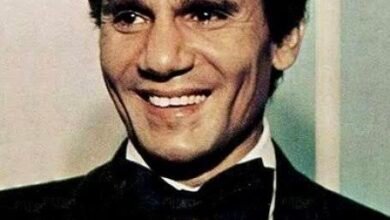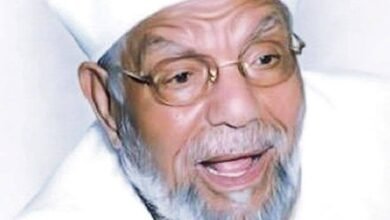د. أيمن صابر سعيد يكتب: علم اللغة الحديث ونظرية السياق

علم اللغة الحديث ونظرية السياق
وهي نظرية من النظريات التي تهتم باستعمال الكلمة وتوظيفها، أو أنها تبحث عن الطريقة التي تستعمل بها داخل سياقات مختلفة؛ ولذا يعتمد عليها اعتماداً كبيراً في فهم المعنى العام في تحليل الشعر والنثر؛ وهو ذهب إليها كثير من أستاذتنا الكبار، وعلى رأسهم ما نادى به الدكتور أحمد مختار عمر حين أكد أن “المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية؛ أي وضعها في سياقات مختلفة”؛ ومن ثم، فإن السياق هو أداء تشكيل المعنى، والمحدد لفهم المعنى في أي نص، على اتساع معناه ونوعه وأدواته.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المعنى المعجمي للكلمة بالضرورة هو متعدد ومحتمل على النحو الفردي، أما إذا بحثنا معنى هذه الكلمة المحددة في سياق واحد فإنه لا تحتمل أكثر من معنى أو يترجح معنى ما، ولا يتعدد بسبب ما في السياق من قرائن وعلامات وإشارات ودلالات تقودنا إلى تحديد المعنى المراد.
وعن علاقة الكلمة المراد تفسيرها بالسياق الواردة فيه نستطيع القول، وهو ما ذهب إليه الدكتور تمام حسان بأن “معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى، وإن معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها”، ومن ثم، فالطريق إلى الفهم الصحيح لمعنى الكلمة هو الاهتمام بسياق الكلمة، والاهتمام -أيضا- بعلاقة الكلمة بغيرها من الكلمات في نفس السياق، ومن الأمثلة التوضيحية لهذه النظرية تفسيرنا لبعض الكلمات المختلفة، نحو كلمتي (عملية)، وكلمة (لعب) في السياق “فكلمة (عملية) تتحدد معانيها المختلفة من وجودها في سياق مرتبط بالطبيب والضابط والتاجر، كما أن السياق يخبرنا بمعنى كلمة (لعب) في سياق مرتبط بالطفل أو الممثل أو الرياضي، وهذا ما قرره (أولمان) أيضا من أن التوصل إلى المعنى الحقيقي خلال عملية الترجمة لا يتم بالأخذ من المعجم، بل إنه وليد المعرفة التاريخية التي اكتسبها المترجم من خلال معرفته للكلمة من خلال استعمالاتها أو سياقات مختلفة”.
وليس المقصود بالسياق السياق اللغوي فحسب، بل هناك سياقات أخرى تساعد على إبراز الفهم الحقيقي للمعنى؛ ولذا فقد اقترح K.Ammer تقسيما للسياق ذا أربع شعب يشمل:
،Linguistic context السياق اللغوي
،Emotional context السياق العاطفي
،situational context سياق الموقف
.cultural context السياق الثقافي
وقد حدد (فيرث) القواعد الضابطة للوصول إلى معنى كلمة أو نص لغوي في ضوء نظرية السياق في النقاط التالية: تحليل السياق اللغوي صوتيا وصرفيا ونحويا ومعجميا، وبيان شخصية المتكلم والمخاطب والظروف المحيطة بالكلام، وبيان نوع الوظيفة الكلامية مدح- هجاء- طلب.. إلخ، وبيان الأثر الذي يتركه الكلام كالإقناع والتصديق أو التكذيب والفرح والألم.
ولعلنا نلحظ التشابه القائم بين الأقوال السابقة في ضوء ما ذكرناه أن الوصول إلى المعنى الحقيقي لا يتم إلا من خلال السياق بصوره المختلفة، وظروفه المحيطة، وهو ما يجب التنبه إليه في الدراسات الأدبية واللغوية التحليلية، وذلك بهدف الوصول إلى فهم المعنى المراد فهما صحيحا يساعد على بيان الدلالة، أو بيان الدور الذي تؤديه الكلمة في السياق. وهناك عوامل أخرى تؤثر في فهم المعنى، بجانب العوامل السابقة، وهي دور الأداء الصوتي والتعبير الجسدي بوصفهما من أدوات التواصل، وإن كانا يرتبطان بحالات التواصل الشفهي لا الكتابي.
ويرجع عدم ثبات المعنى اللغوي في جميع سياقاته إلى أن الكلمات -كما ذهب الدكتور كمال بشر- إلى أن الكلمات “لا تعيش منعزلة في نظام اللغة، ولكنها تندرج تحت أنواع شتى من المجموعات والتقسيمات التي يرتبط بعضها ببعض بواسطة شبكة من العلاقات المعقدة غير المستقرة المتوغلة في الذاتية: علاقات بين الألفاظ، وعلاقات بين المدلولات، وعلاقات أساسها التشابه أو بعض الصلات الأخرى، وهذه العلاقات المترابطة إنما نشعر بها عن طريق آثارها ونتائجها”.
ومما تجدر الإشارة إليه -دون ميل أو تحيز- أن نظرية السياق لها جذور عربية أصلية، تدل على أن العرب قد سبقوا الغرب في معرفة هذه الأصول، ومن الأدلة على صحة ما ذهبنا إليه، أن اللغويين العرب القدماء قد تنبهوا إلى ما أطلق عليه (المقام، والمقال)، وقد وردت في أشعارهم الجاهلية والإسلامية؛ مما يدل على معرفة العرب لهما قبل الغرب، ومن ذلك قول الحطيئة:
تحنن على هداك المليك
فإن لكل مقام مقال.
وقول زهير بن أبي سلمي.
لما أسمعتكم قذعا ولكن
لكل مقام ذي عان مقال
وقول طرفة بن العبد:
لخولة بالأجزاع من إضم طلل
وبالسفح من قو مقام ومحتل
كما وردت هذه المقولة المشهورة “لكل مقام مقال” ضمن الأمثال العربية الموروثة لـ (أكثم بن صيفي). كل هذه الأدلة السابقة، وغيرها، تؤكد الأصول العربية لهذه النظرية، وأن ما جاء به فيرث وغيره من الباحثين لهو مبني على الجذورالعربية القديمة.
وأخيرا، فإن الكلمة المفردة لا يتحدد معناها إلا من خلال السياق، ومن خلال ملاحظة الوحدات الأخرى التي تتضافر معها. ومن ثم، فالكلمة ببساطة شديدة هو تفاعل دلالي نحوي في آن واحد، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، أو دراسة أحدهما بمعزل عن الآخر، فهما كتلة واحدة.