الذات بين القهر والمقاومة: قراءة في رواية “الحرب في بر مصر”
تُعد رواية “الحرب في بر مصر” للكاتب يوسف القعيد 1978م، واحدة من أبرز الأعمال الروائية التي تناولت حرب أكتوبر 1973 -أو لنقل نتائج ما بعد الحرب- برؤية مختلفة عمّا درج عليه الأدب في مصر والعالم العربي. فبينما انشغلت كثير من الأعمال بتصوير البطولات العسكرية وأمجاد الجيوش، انحاز يوسف القعيد إلى الإنسان البسيط عامة، وبخاصة إلى الجندي الفلاح الذي وجد نفسه فجأة في قلب المعركة، يحارب من أجل وطن لا يدرك تمامًا ملامحه الكبرى، لكنه يعرف أنه يحب ترابه، ويخاف عليه، ولا يمكن أن يتركه لعدو يدنسه. الرواية هنا ليست مجرد سرد لوقائع حرب، بل شهادة إنسانية على لحظة تاريخية شكلت وعي جيلٍ كامل، وهي أيضًا نصٌّ فني يختبر العلاقة بين الحرب والحياة، بين الانتصار الخارجي والهزيمة الداخلية، ويتوقف طويلا عند الجانب الإنساني الاجتماعي.
وتدور أحداثها حول قرية مصرية قبيل حرب أكتوبر 1973؛ حيث يزوّر العمدة وثائق تجنيد ابنه الحقيقي ليحل محله ابن خفيره “الفلاح البسيط”، واسم الابن “مصري”، طالب فقير كأبيه لكنه متفوق في الدراسة رغم كل الصعوبات، ولديه أسرة كبيرة العدد، وبعد ذهابه للجيش يستشهد،”مصري” ابن الخفير، ويصرف لأسرته مستحقات الشهيد. ومن لحظة تسليم جثته تبدأ الرواية في التعقيد، وطرح أسئلة كثيرة للوصول إلى الحقيقة.
أولًا: بين الواقعية والتوثيق الأدب
ينتمي يوسف القعيد إلى جيل الكتّاب الذين تأثروا بالواقعية الجديدة في الأدب المصري، تلك التي مزجت بين السرد الفني والهمّ الاجتماعي والسياسي – كما رأينا عند الكاتب جمال الغيطاني في روايته عن البطل إبراهيم الرفاعي. وفي “الحرب في بر مصر” يواصل الكاتب هذا الاتجاه بأسلوب يجمع بين الواقعية التسجيلية والرمزية الفنية. فالرواية تبدو في ظاهرها أقرب إلى تقرير واقعي عن جنود في جبهة القتال، لكنها في العمق تقدم تأملًا وجوديًا في معنى الحرب والوطن والانتماء.
منذ الصفحات الأولى، يضعنا القعيد أمام عالمٍ قروي بسيط؛ عالم الفلاحين الذين يشكلون القاعدة البشرية للجيش المصري. وقد لا يملكون وعيًا سياسيًا متطورًا كأبناء المدينة، ولا شعارات كبرى، لكنهم يحملون حسًّا فطريًا بالواجب الوطني وقيمة ذرات تراب الوطن. ومن خلال هذا المنظور، تتحول الحرب من حدث سياسي إلى تجربة إنسانية؛ فالميدان ليس فقط ساحة قتال، بل مرآة تعكس طبيعة الإنسان المصري حين يُختبر في أقسى الظروف، “ظروف الحرب ونتائجها”.
ثانيًا: بنية الرواية وزمن السرد
تعتمد الرواية على بناء سردي غير تقليدي؛ إذ تتداخل فيها الأزمنة والأصوات. فالكاتب لا يروي الأحداث بطريقة خطّية، بل يقفز بين مشاهد الحرب ومشاهد الحياة في القرية، بين الجبهة والبيت، بين صوت الجندي وصوت الأم أو الحبيبة أو الرفيق الذي سقط في المعركة. هذه التقنية تمنح النص حيوية درامية، وتجعل القارئ يعيش تشتت الوعي الذي يعيشه الجندي نفسه؛ حيث تمتزج الذكريات بالواقع، والموت بالحياة.
كما يستخدم الكاتب لغة تتراوح بين البساطة الريفية والعمق الفلسفي، وهو ما يعكس تباين مستويات الوعي لدى الشخصيات. في كثير من المواضع، تبدو اللغة أقرب إلى التسجيل الشفوي، وكأننا نستمع إلى حكايات الجنود أنفسهم؛ مما يعزز الإحساس بالصدق والحميمية. وفي مواضع أخرى، تتخذ اللغة طابعًا تأمليًا شعريًا حين يتحدث السارد عن معنى الحرب أو عن مصير الإنسان أمام آلة الموت.
ثالثًا: الشخصيات بين الرمزية والواقعية
تُبنى الرواية على مجموعة من الشخصيات التي تمثل شرائح المجتمع المصري في تلك المرحلة. العمدة، والخفير، والجندي الفلاح هو بطلها المحوري الذي يمثل استشهاده ذروة التعقيد، لكنه ليس بطلًا فرديًا؛ إنه رمز لجماعة كاملة من المصريين الذين حملوا عبء الحرب دون أن يُذكروا بالاسم. يظهر هنا أسلوب يوسف القعيد المميز في تفكيك البطولة التقليدية: فالبطل ليس من يصنع المعجزات، بل من يصمد ويقاوم ويؤمن، رغم الخوف والجوع والشك والقهر.
الشخصيات الثانوية -الأم، الحبيبة، الرفاق- تؤدي أدوارًا رمزية أيضًا. فالأم تمثل الوطن في أقصى تجلياته الحنونة والمؤلمة، والحبيبة ترمز إلى الحياة المؤجلة التي تظل تنتظر الجندي بعد الحرب، والمتعهد، وزوجات العمدة، وكل من شارك العمدة في إتمام جريمته، وهم كثر. أما الرفاق فيجسدون المصير الجمعي، مصير الجماعة التي تواجه الموت معًا. بهذا التشكيل، تتحول الرواية إلى أنشودة جماعية أكثر منها حكاية فردية، تعكس رؤية القعيد عن تلاحم الإنسان والمكان والزمان في لحظة المصير الوطني؛ حيث تتشابك التضحيات والبطولات الجماعية من أجل الحياة والوطن.
رابعًا: المكان ودلالته الرمزي
كلمة “البر” في المخيلة المصرية يرتبط بالموت أو الجانب الآخر بوجه عام؛ إذ كانت الضفة الغربية للنيل في مصر القديمة (البر الغربي) -كما هو معروف تاريخيا- موضع المقابر والمعابد الجنائزية. ومن هنا، يحمل العنوان دلالة مزدوجة: فهو يشير جغرافيًا إلى منطقة العمليات الحربية في غرب القناة، لكنه يرمز أيضًا إلى الموت الجماعي الذي تخلفه الحرب، وإلى عبور الإنسان من الحياة إلى الفناء. هذا التداخل بين المكان الواقعي والرمز التاريخي يضفي على الرواية بعدًا فلسفيًا عميقًا، يجعل الحرب نوعًا من الرحلة الوجودية بين الضفتين، بين الحياة والموت، بين الهزيمة والانتصار، وكذلك البر الآخر المقابل لمكان الحرب، أو ضفة العمليات الحربية والضفة المقابلة لها بلا فارق.
خامسًا: الحرب بوصفها اختبارا للوعي والهوية
لا يتعامل يوسف القعيد مع الحرب بوصفها حدثًا عسكريًا فحسب، بل بوصفها اختبارا شاملا لوعي الإنسان المصري بعد سنوات من الانكسار (هزيمة 1967)، ثم الأمل في الاسترداد (نصر 1973). ومن خلال شخصياته، يطرح تساؤلات حول معنى الوطن، وجدوى القتال، وحدود التضحية. فالرواية لا تمجّد الحرب، بل تُعرّيها من الزيف الدعائي لتكشف عن وجهها الإنساني المؤلم. في لحظات كثيرة، يبدو الجندي مترددًا بين الإيمان بالمعركة والخوف من عبثها، بين شعور الواجب وغريزة البقاء. وهنا تبرز عبقرية الكاتب في رسم التناقض الداخلي للإنسان حين يواجه الموت من أجل إيمانه العميق بالوطن.
سادسًا: الأسلوب واللغة
لغة يوسف القعيد في “الحرب في بر مصر” تتميز بخصوصية شديدة. فهي لغة بسيطة أحيانًا، ومشحونة بالعاطفة أحيانًا أخرى، تجمع بين العامية والفصحى دون أن تفقد اتزانها الفني. هذه الازدواجية اللغوية تعكس تعدد الأصوات داخل الرواية: صوت الفلاح البسيط (الخفير)، صوت الراوي العليم، وصوت الجماعة الوطنية التي تتحدث من خلف النص، كما يستخدم الكاتب التكرار والإيقاع الداخلي ليمنح السرد طابعًا شبه شعائري، خاصة في مقاطع الحديث عن الموت أو الانتظار، وهو ما يجعل النص قريبًا من التراتيل أو المونولوجات النفسية. ومن ذلك -على سبيل المثال- الحوار الذي يدور بين فلاح من القرية ومن ذهبوا لتسليم جثة الشهيد:
فجأة التفت إلى الفلاح وسألني: ذاهبون لمن في البلد؟
ذكرت اسم والد الشهيد المدون في الأوراق معي. وكان الاسم قد علق بذهني من كثرة إخراجي للورقة وقراءتها. قال الرجل: إنه عمدة البلد وهو موجود.
ولأن السائق يصر على المشاركة في كل الأحاديث . أشار إلى صندوق السيارة، وقال للفلاح:
– البقية في حياتك. خبط الرجل صدره بفزع:
بعد الشر. من؟!
ابن العمدة.
لم يكن للعمدة أبناء يعالجون في البنادر. أم هو حادث؟
صاح فيه السائق بغضب.
أي حادث إنه شهيد.
تساءل الفلاح؟
في الحرب ؟
الحمد لله على إنك فهمت.
فكر الرجل في الأمر وظهر على وجهه الاهتمام. رفع يده فجأة:
ولكن العمدة ليس له أولاد في الجيش.
خرج صديق الشهيد من صمته، وسأل الفلاح:
ومن أدراك؟
أنا متأكد
ونحن أيضاً متأكدون
لحظة الصمت الطارئة لم تحمل الاطمئنان لأحد منا. بدأ الرجل قلقاً وكأنه فقد القدرة على الجلسة المريحة. ولهذا تساءل:
كل أبناء العمدة الذكور أعفوا من التجنيد وفاتوا سنهم أصغر أبنائه، وهو الوحيد الذي كان يجب أن يجند في البلد.
متى شاهدته؟
صباح اليوم وسلمت عليه
قال صديق الشهيد بمرارة:
قد يكون للعمدة ابن لا تعلمون عنه شيئا.
أدرك الفلاح السخرية في الحديث، فقال بمرارة أكثر:
من يدري، ربما كان ابن العمدة ولياً، قادر على أن يوجد في مكانين معاً في وقت واحد. ألسنا في زمن المعجزات؟
سابعًا: البعد الإنساني والفكر
من أهم ما يميز هذه الرواية أنها لا تسعى إلى تمجيد الحرب، بل إلى كشف النفس البشرية وتعريتها. فالكاتب لا يقدّم أبطالًا خارقين، بل بشرًا يخافون ويحلمون ويحنّون إلى بيوتهم. الحرب هنا ليست فقط مواجهة مع العدو، بل مع الذات أيضًا. ومن خلال هذا المنظور، يقدّم رؤية فلسفية تقول إن الانتصار الحقيقي ليس فقط عبور القناة، بل عبور الخوف والشك إلى الإيمان بالحياة.
كما يمكن قراءة الرواية بوصفها نقدًا غير مباشر للسلطة والسياسة؛ إذ تبرز في خلفيتها ملامح البيروقراطية والتهميش والاغتراب الاجتماعي، وهي قضايا ظل يوسف القعيد يثيرها في مجمل أعماله. فالحرب في نظره ليست حدثًا منفصلًا، بل نتيجة لتاريخ طويل من الظلم الاجتماعي الذي جعل الفقراء هم وقود المعارك وأبطالها الصامتين.
ثامنًا: القيمة الأدبية والتاريخية
تأتي أهمية “الحرب في بر مصر” من كونها وثيقة سردية عن حرب أكتوبر من داخل التجربة الشعبية، لا من مكاتب القادة أو نشرات الأخبار. وقد نجح يوسف القعيد في أن يمنح الحرب صوتًا إنسانيًا صادقًا، بعيدًا عن الخطاب الدعائي الذي طغى على كثير من الأعمال اللاحقة. ولهذا، تُعد الرواية من العلامات البارزة في أدب ما بعد النصر، إلى جانب أعمال جمال الغيطاني وإبراهيم عبد المجيد وغيرهما.
وقد حولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي عام 1991م، بعنوان “المواطن مصري”، مجسدة أحداث الرواية بالصوت والصورة، في ثنائية رائعة بين شخصية العمدة القاهرة، وشخصية الفلاح المقهورة، البسيطة المغلوبة على أمرها، وبينهما الابن الذي ضحى بنفسه من أجل الوطن، ومن أجل أسرته. “من الذي استشهد ابن الخفير الذي ذهب بنفسه ، أم ابن العمدة الذي أناب شخصاً آخر مكانه لكي يستشهد بدلاً منه. ويترتب على حسم هذه المشكلة حل مشكلة أخرى ستطرح نفسها في الأيام القادمة، وهي من الذي يصرف مستحقات الشهيد المالية، العمدة أم الخفير؟ حتى الآن رسمياً: الذي يصرف هذه المستحقات -وهي كثيرة- العمدة. ولكن ما ذنب الخفير هل تعتمد على ضمير العمدة اليقظ ونطلب منه أن يصرفها ويعطيها أو جزءاً منها للخفير، وهو حر في ذلك. أم نقسمها بين الاثنين. إن ما حدث لا يدخل تحت بند الجرائم؛ لأنه عمل مشروع. ألا يجوز الإنابة والتوكيل في الانتخابات؟. إن الانتخاب عمل وطني وما دامت تجوز فيه الإنابة؛ فهي تجوز أيضاً في الحروب. كل هذا مضى وانقضى، ما فات ما . ولكن الذي يجب بحثه الآن، هو من الذي تصرف له مستحقات الشهيد المالية؟
وأخيرا وليس آخرا، رغم ضياع الحقيقة وتكريم العمدة بوصفه “أبا للشهيد”، وهي نهاية ساخرة تكشف عن الظلم الاجتماعي وصراع الطبقات، وقهر الفلاحين وتزوير الحقائق لصالح الأغنياء؛ ولذا يمكننا القول إن رواية “الحرب في بر مصر” ليست مجرد نص عن الحرب، بل تأمل في معنى الوجود ذاته في مواجهة الفناء.
لقد حوّل يوسف القعيد المأساة الوطنية إلى تجربة فنية كاشفة، وأعطى صوتًا لأولئك الذين حاربوا في صمت، وعادوا إلى قراهم دون أن يعرفهم أحد؛ سواء أحياء أم شهداء. بهذه الرؤية، تجاوزت الرواية حدود الحدث التاريخي لتصبح نصًا عن كرامة الإنسان ومحدودية قدرته على الفهم والمقاومة. إنها شهادة فنية على أن الحرب، مهما كانت عادلة، تظل جرحًا مفتوحًا في ضمير الأمة بأحداثها وما يدور فيها وحولها، وأن الكتابة عنها هي محاولة للشفاء -أو على الأقل- للتذكّر والعظة والحذر، ورغبة في التغيير، والقضاء على السلبيات.




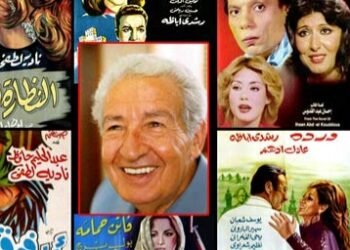









đăng nhập 188v Càng tham gia lâu dài và tích cực, người tham gia sẽ càng được hưởng những ưu đãi lớn hơn. Các thành viên VIP của nhà cái thường nhận được phần quà đặc biệt, tỷ lệ hoàn tiền cao hơn, cả những ưu đãi cá nhân hóa như quản lý tài khoản riêng, hỗ trợ ưu tiên cùng nhiều quyền lợi khác.
đăng nhập 188v Càng tham gia lâu dài và tích cực, người tham gia sẽ càng được hưởng những ưu đãi lớn hơn. Các thành viên VIP của nhà cái thường nhận được phần quà đặc biệt, tỷ lệ hoàn tiền cao hơn, cả những ưu đãi cá nhân hóa như quản lý tài khoản riêng, hỗ trợ ưu tiên cùng nhiều quyền lợi khác.
66b chính thức Giao diện website và ứng dụng cũng chính là điểm gây ấn tượng đặc biệt với hội viên. Nền tảng cho sử dụng màu sắc hài hòa, đơn giản nhưng khi kết hợp với nhau tạo cảm giác thu hút đặc biệt. Ngoài ra, hệ thống điều hướng, danh mục đều sắp xếp vô cùng khoa học nên dù bạn có là thành viên mới thì cũng sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin mong muốn nhanh chóng.
Chính thức “chào sân” vào năm 2012, 888slot link là một nhánh nhỏ trực thuộc sự quản lý của CURACAO Gaming, cơ quan giám sát cờ bạc hàng đầu Châu Á. Ngay từ thời điểm ra mắt, nhà cái chúng tôi đã có trụ sở chính thức tại hai trung tâm cờ bạc lớn nhất Philippines là Manila và Costa Rica.
Chính thức “chào sân” vào năm 2012, 888slot link là một nhánh nhỏ trực thuộc sự quản lý của CURACAO Gaming, cơ quan giám sát cờ bạc hàng đầu Châu Á. Ngay từ thời điểm ra mắt, nhà cái chúng tôi đã có trụ sở chính thức tại hai trung tâm cờ bạc lớn nhất Philippines là Manila và Costa Rica.