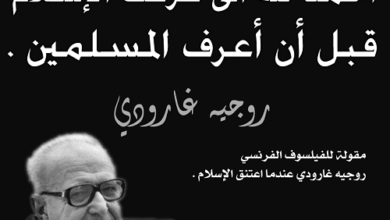د.أيمن صابر سعيد يكتب: علم اللغة ونظرية المجالات الدلالية

علم اللغة ونظرية المجالات الدلالية
مما لا شك فيه أن فهم الطبيعة الحقيقية للغة ما.. لا يمكن إدراكه ومعرفته معرفة جلية إلا من خلال فهم المعنى اللغوي لهذه اللغة؛ إذ إن المعنى يؤدي دوراً فعالاً في جميع المستويات اللغوية المختلفة؛ بدءًا من أصغر وحدة لغوية وانتهاء بأكبر وحدة لغوية.
وقد اهتم اللغويون، وسعوا سعيا دؤوبا، منذ القدم إلى جمع اللغة واستخلاصها من مصادرها المعتمدة، وفرقوا بين الأخذ عن أهل البادية وأهل الحاضرة؛ ولذلك اهتموا بالنصوص الأدبية عامة، والشعر خاصة، ولا غرابة في ذلك؛ فالشعر ديوان العرب، ومرآة كاشفة عن حياتهم في شتى نواحيها، وعاكسة في الوقت ذاته لتفاصيل كل الأمور ، ولم يكن الاهتمام بالشعر من أجل رصد الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية فحسب، بل كان من أجل الاهتمام باللغة نفسها؛ ولذلك استدلوا على القواعد النحوية بصحيح الشعر العربي، وعرف ما يسمى بعصور الاحتجاج، كالعصر الجاهلي وصدر الإسلام والعصر الأموي، واستمر ذلك الاحتجاج بالشواهد الشعرية حتى سنة 150 هجريا في الحاضرة، وحتى منتصف القرن الرابع الهجري في البادية.
وفي عصرنا الحديث ارتبطت الدراسات اللغوية بالدراسات الأدبية ارتباطاً وثيقا، حيث إن النظريات اللغوية الحديثة أصبحت في خدمة الدراسة الأدبية من الناحية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والمعجمية، بجانب تتبع الظواهر اللغوية في تلك الدراسات الأدبية، ومن ثم، فهناك عطاء لغوي متبادل بين تلك الدراسات منبعه علم اللغة الحديث؛ ولذا كان لزامًا علينا أن نفيد من نظريات علم اللغة الحديث، ونقوم بتطبيقها على النصوص الشعرية القديمة والحديثة، بهدف تأكيد أهمية العلاقة بين النحو والدلالة، والانطلاق من المدخل النحوي لفهم النصوص الشعرية، وظهر في هذا الشأن عدة نظريات، ومنها:
نظرية المجالات الدلالية Semantic Fields Theory
تعد هذه النظرية من أهم نظريات تحليل المعنى في الدرس اللغوي الحديث؛ إذ إنها تهتم بتصنيف المفردات في إطارها النصي؛ ولم يعد الأمر -كما كان متعارفا عليه لقرون طويلة- مجرد النظر إلى الكلمات على أنها وحدات دلالية ومعجمية مستقلة ومتناثرة لا صلة بينها، بل توسع الأمر في البحث عن العلاقات الدلالية الكلية والعامة والخاصة الرابطة بينها للوصول إلى خيط واحد جامع، في صورة حقل من الحقول الدلالية.
وبدأ تغيير النظرة لدى العلماء المتخصصين في علم اللغة، ومنهم ليونز Lyons الذي عرف معنى الكلمة بأنها “محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي”. وبدأ الكشف عن هدف التحليل للحقول الدلالية المختلفة من خلال جمع كل الكلمات ذات الملامح الواحدة التي يمكننا تصنيفها في حقل واحد، ثم البحث في الصلات الواصلة بينها، على المستوى العام والخاص.
وقد بدأت هذه النظرية في القرن العشرين في الذيوع والانتشار على أكتاف مجموعة من الباحثين في أوروبا وأمريكا، وتطورت بجهود مجموعة من العلماء مثل إبسن، وتيرير وغيرهما، ومن ثم ظهرت -كما يقول د. حلمي خليل وغيره أمثال د. أحمد مختار عمر ود. محمود فهمي حجازي ومن ذهب مذهبهم- نظرية المجالات الدلالية التي تقوم بـ “تنظيم الكلمات في مجالات أو حقول دلالية؛ فهناك مجالات تتصل بالأشياء المادية كالألوان، والزهور والنباتات والمساكن، وهناك مجالات أخرى تعبر عن جوانب غير مادية مثل الحب، والفن والدين، وغيرها، ومن ثم حاول العلماء تصنيف الكلمات طبقا لمدى علاقاتها بمجال دلالي معين، والأصل في هذه النظرية هو التسليم بوجود علاقات دلالية بين مجاميع معينة من الكلمات، فمثلاً كلمة (نبات) ترتبط من الناحية الدلالية بكلمة (شجرة) وبغض النظر عن الخصائص الدلالية التي تمتاز بها كل كلمة عن الأخرى، وترتبط كلمة (شجرة) بكلمات أخرى لها نفس العلاقة مثل: كلمتي ( الخضرة) أو ( الاخضرار اللتين تؤديان بدورهما إلى أنواع من الأشجار والنباتات”.
ومن الأمثلة التوضيحية لهذه النظرية أيضا ما ذكره د. محمود سليمان ياقوت ما يعرف بالدرجات الجامعية “فمن المعروف أن الدرجات الجامعية هي: معيد- مدرس- مساعد مدرس- أستاذ مساعد -أستاذ. إن تحليل كلمة (معيد) -مثلاً- يتم في إطار مجالها الدلالي الخاص بالدرجات الجامعية؛ لأننا لو انتزعناها منها لكان معناها -مثلاً- من يعيد الثانوية العامة، وتحليل كلمة (مدرس) تدل في الحياة الجامعية على من يحمل شهادة الدكتوراه، في حين أنها في مجال دلالي آخر تشير إلى من يعمل بالتدريس في مراحل التعليم العام”.
ومما تجدر الإشارة إليه أن نظرية المجالات الدلالية فكرة عربية قديمة؛ قدمها العرب القدماء تحت اسم “الرسائل اللغوية”، التي تضم مجموعة من الكلمات المتعلقة بموضوع ما، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مجموعة الرسائل الخاصة بموضوع (الإبل) لعدد من اللغويين مثل: أبي عبيدة (ت210 ) هـ، وأبي زيد الأنصاري (ت ٢١٥ هـ)، والأصمعي ( ت ٢١٦ هـ)، والباهلي (ت ۲۳۱ هـ)، وابن الأعرابي ( ت ۲۳۱ هـ)، وابن قتيبة ( ت ٢٧٦هـ) وغيرهم، وفي مجال خلق الفرس والخيل والإنسان مثل: رسائل ابن دريد (۳۲۱هـ) وغيره من اللغويين، وهناك مجموعة أخرى في موضوع ( الأنواء) للنصر بن شميل ( ت ٢٠٤هـ)، وقطرب (ت ٢٠٦هـ)، و)في المياه والسحاب والمطر) و(النبات والشجر والزرع( رسائل متعددة جمعها لغويون آخرون.
ليس هذا فحسب، بل هناك مؤلفات كاملة تدور في المجالات الدلالية، وهي ما أطلق عليها معاجم الموضوعات، ومن أشهرها: الغريب المصنف، لأبي عبيدة القاسم بن سلام (۲۲۳ت)، كتاب الألفاظ لابن السكيت ( ت ٢٤٤ هـ)، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ( ت ٤٢٩هـ)، المخصص لابن سيده ( ت ٤٥١هـ).
ومن ثم، فلا سبيل إلى إنكار أصل هذه النظرية العربية القديمة ، وإن كانت هناك جهود غربية حديثة مهمة في هذا الشأن من مثل ما قدمه فارتبورج في تصنيفه المشهور؛ حيث قسم الكلمات إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: الكون والإنسان، والإنسان والكون، وكذلك تصنيف نيدا Nida وهو ما يصلح لجميع اللغات المختلفة؛ حيث اقترح تصنيفاً آخر يضم أربعة مجالات دلالية وصفها بأنها عالمية، ويمكن أن تنطبق على اللغات كلها، وهي كما يأتي:
الموجودات Entities: وهو من أكبر المجالات، ويشمل الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة.
2- الأحداث Events وتتمثل في الأفعال الدالة على الحوادث المختلفة من الطبيعة والحياة اليومية والنشاطات المختلفة، والحواس والعواطف والمصادمات.
3- المجردات Abstracts وتشمل الكلمات التي تعبر عن الكيفيات والدرجات مثل: الزمن والحجم والسرعة واللون والعدد والمنزلة… إلخ..
4- العلاقات Relations: وتتمثل في العلاقات بين الموجودات والحوادث والمجردات كما تجدها في حروف الجر والظروف.
وهناك مجموعة من المبادئ اتفق عليها أصحاب هذه النظرية، ومنها:
1- لا وحدة معجمية Lexem عضو في أكثر من حقل
.2- لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين.
3- لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة.
4-استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي.
وهذه المبادئ الأربعة يجب أن نضع في اعتبارنا دور المجاز في اللغة، وتحولات الكلمة من مجال إلى مجال آخر، ومن ثم تكتسب دلالات جديدة في كل موقع توظف فيه الكلمة الواحدة.
وخلاصة القول نريد تأكيد فكرة أن المجالات الدلالية ليست مجرد تصنيف للكلمات التي تعبر عن الإنسان وما يتعلق به والحيوانات والنباتات والماء والحشرات والطبيعة والكائنات غير المرئية والكيانات الجامدة… إلخ، وإنما هي إبراز السمات الدلالية الناتجة عن العلاقات الدلالية بين الكلمات المصنفة في عقول أبناء اللغة لاعتبارات عقلية وذهنية مختزنة بطريقة ما في المجال الدلالي الواحد؛ بغية الوصول إلى نتائج بحثية متكاملة في ضوء نظرية المجالات الدلالية